من أهم مقومات بناء الحضارة وتحصين الذات، التركيز على تحسين أداء المنظومة التعليمية وتجويد مردوديتها، من حيث التنظير العلمي والبيداغوجي للمعارف وتصميم البرامج والمقررات ومراعاة الأولويات من مدخلات ومخرجات، لأن بالعلم والتعلم تسود الأمم والدول، ويقاس منسوب الحضارات وتقدمها، ولأن قوتها سبب للشرف والرفعة بين أقرانها، ولهذا أولى المسلمون قديما عبر التاريخ القديم حكاما ومحكومين، علماء ومفكرين للمنظومة التعليمية كل العناية والاهتمام، فصاروا أئمة الأمم وأسياد الدول، ولكن كما قال أبو البقاء الرندي في نونيته:
لكل شيء إذا ما تم نقصــــــــــــان فلا يُغَر بطيب العيش إنســــــــــــــــان
هي الأمور كما شاهدتهـــــــــــا دول من سره زمن ساءته أزمــــــــــــــــــان[1]،
فبعد ظهور العولمة والدعوة إلى الحداثة ظهر ضعف الأمة الإسلامية ودخل عليها الانحلال من كل مدخل حتى بلغ الأمر إلى المدارس والجامعات والمعاهد والكليات، بل وصل إلى المناهج والمقررات، ولعل أبرز المؤشرات والعلامات هو ما تعيشه بعض الجامعات العربية عموما، من تفكك معرفي وقيمي، وانفصال تام أو شبه تام بين الهوية الإسلامية وبين المعارف الأكاديمية المدرسة، في غياب تام لنظرة تكاملية متناسقة بين علوم الوحي وعلوم الكون، وهذا الأمر يحيلنا إلى الرجوع إلى التراث الإسلامي واستنطاقه لمعرفة أصل العلوم وطبيعتها والعلاقات بينها في تصور علماء ومفكري الأمة، وهنا نطرح التساؤلات التالية :
- إلى أي حد يمكن القول أن علماء الأمة الإسلامية قديما كانوا يدركون وجود تكامل وتقاطع بين علوم الوحي وعلوم الكون؟
- وهل الدعوة إلى تكامل العلوم دعته الضرورة العصرية بعد تشعب العلوم وتفككها أم سبق السلف إلى هذه الدعوة والتنبيه عليها؟
- وما هو واقع الجامعات الأكاديمية في ظل غياب النظرة التكاملية للعلوم؟
- وما هي الأسباب والتداعيات الحقيقية التي تفرض علينا اللجوء إلى التخصص؟
- وهل هناك إمكانية الجمع بين علوم الوحي وعلوم الكون اعتمادا على ما وصلنا من التراث الإسلامي؟
المقصود من نظرية التكامل المعرفي
تؤكد المعاجم اللغوية أن مادة (ك م ل) تدل على التمام بعد التجزئة، وتوحي أيضا أن جزء الشيء أو الأجزاء المتعددة للشيء الواحد قد اتحدت وتوحدت واندمجت واختلطت، وأخذت شكلا واحدا، ولهذا فقد اكتمل وتم[2]، ومنه قوله تعالى:{اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي}[3]، وهذا المعنى يرشدنا إلى المعنى الاصطلاحي للتكامل المعرفي والمعبر عنه بإتمام العلوم بعضها لبعض حتى تحصل المعرفة بالشيء معرفة تامة وحسنة، والمقصود من نظرية التكامل المعرفي هنا هي تلك الصورة العلمية المتكاملة للوجود والذات، المتحققة بتفعيل الرؤية الإسلامية في كل مجالات المعرفة، سواء أكانت علوما طبيعية أم اجتماعية أم إنسانية أم شرعية، ومن أجل توضيح المقصود من نظرية التكامل المعرفي لابد من التأكيد على المسائل التالية:
- أن ثمة مصدرين للمعرفة لا ثالث لهما؛ الأول: هو الوحي الذي يتمثل بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والثاني: هو الكون والعالم بمجالاته الثلاثة (الطبيعية والاجتماعية والنفسية)، وهو المصدر الذي أمر الخالق سبحانه وتعالى الإنسان بالنظر والبحث والسير فيه، للتعلم والاكتشاف، ووعده بتيسير سبل هذا التعلم (سنريهم آياتنا، قل انظروا، قل سيروا، ألم تر، ألم يروا…)، كما يتبين أن ثمة نوعين من أدوات الاستمداد من هذين المصدرين؛ هما نوعان من الأدوات لا ثالث لهما أيضا، ويعملان معا بصورة متلازمة: الأولى: الحواس البشرية، والثانية: هي العقل البشري، وقد يقع الخلط أحيانا بين المصدر والأداة في بعض المقامات من غير التفريق بينهما لشدة ارتباطهما في إنتاج المعرفة.
- أن مبدأ التوحيد هو الأساس والأصل الذي تنطلق منه فكرة تكامل المعرفة البشرية في مرجعية واحدة؛ هي الله سبحانه، سواء أوحي الله تعالى بهذه المعرفة عن طريق الرسل والكتب المنزلة، أو وهبها لخلقه عن طريق الاكتساب أو الكشف من خلال التعامل مع الكون الذي نعيش فيه فهما وتسخيرا، وكذلك يتجلى مفهوم التوحيد في كون أدوات المعرفة البشرية هي هبة من الله للإنسان، وهذه الأدوات هي الحس المادي والنظر العقلي، قال تعالى: “وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.”[4] ولهذا فإن وحدة المعرفة من حيث المصدر والأداة أساس تكامل علوم الوحي مع علوم الكون.
- فهذه النظرة التوحيدية هي التي تجمع الإنسان والكون في علاقة مركبة لا تناقض فيها ولا تعارض، بل تتكامل وتتضافر فيها المفاهيم من أجل تحرير الإنسان من عبودية الطبيعة وألوهية الهوى الذاتي أو الحزبي، إلى توحيد الخالق الديان رب الكون والإنسان، كما تجعل هذه النظرة أصل العلاقات بين البشر مبنيا على التعارف والتدافع لتحقيق مبدأ الاستخلاف وعمارة الأرض التي جاء بها القرآن الكريم، في حين أن أصل المعرفة عند الغربيين ينحدر من نظرتهم الفلسفية المادية للكون مع إقصاء الجانب الروحي بشكل كبير وتغييب الدين (المحرف) في تسيير الخلق والعالم علميا وفكريا وسياسيا، فبعد إقصاء الكنيسة صار مصدر المعرفة عندهم ينحدر من الفلسفة بمختلف ألوانها وأشكالها.
- الحديث عن التكامل المعرفي نطاقه واسع وشامل لأن هناك تكامل بين المصادر نفسها، وتكامل بين الأدوات، وتكامل بين المصادر والأدوات، وتكامل في الطبائع والوقائع، والمثل والقيم، وتكامل بين العلم والعمل، وتكامل بين الحقيقة والشريعة، وتكامل بين عالم الشهادة وعالم الغيب، وتكامل بين الدين والدنيا، وتكامل بين النقل والعقل، وغيرها من الصور التكاملية، ولكن المقصود عندنا في هذا المقام هو التكامل بين علوم الوحي وعلوم الكون من أجل إقامة الحضارة وبناء الذات وتحقيق مبدأ الاستخلاف في الأرض.
واقع الجامعات في ظل غياب النظرة التكاملية للعلوم
اجتمع الباحثون في الشأن التربوي على ضعف وهشاشة المنظومة التعليمية في بعض الدول العربية، وهذا واضح من خلال مجموعة من المؤشرات والعلامات، ولعل أوضحها وأجلها ما وصل إليه المجتمع الإسلامي بكل أطيافه من انتهاكات صارخة للقيم الإسلامية والإنسانية، وغياب ثمرات العلم والتعلم في بناء وعي سليم وحضاري في المجتمع، وكذا تحصين النفس من الانحرافات والانزلاقات اللاأخلاقية، ومن بين مؤشرات الضعف كذلك، ما يعيشه الطالب الجامعي من شرخ كبير بين هويته وتكوينه، فهو يواجه في معظم التخصصات الجامعية نظريات مستوردة وأفكار دخيلة ووافدة، تهدد هويته الحضارية وشخصيته الفطرية، مثل نظريات (فرويد) في علم النفس، ونظريات (ماركس) في الاقتصاد، ونظريات (أفلاطون) و(ديكارت) و(جون ديوي) في الفلسفة، ونظريات (تشارلز داروين) في الطبيعيات والجيولوجيا، و(جاليليو جاليلي) في الفلك و(ألبرت أينشتاين) و (إسحاق نيوتن) في الفيزياء، و(رونالد دوركين) في القانون والسياسة والحكامة، وفي مجال اللسانيات يعيش طالب الدراسات اللغوية في متاهة بين الأدب الفرنسي والأدب الإنجليزي، وفي مجال الطب تجد الطالب لا يعرف عن تاريخ الطب الإسلامي إلا النزر اليسير ولا يعلم شيئا عن أعلامه ورجالاته وإنتاجاتهم في الطب والكيمياء… وغير ذلك من العلوم التي تجد مناهجها وأفكارها مستوردة من هنا وهناك ولا سيما من الدول الغربية، وأما طالب العلوم الشرعية فهو بين اكتساب قناعات شخصية ومذاهب فكرية شرقية، وبين تراكم معارف وعلوم منفصلة عن أخواتها من غير منهج تفكيري أو نقدي، من قبيل تحصيل الفقه من غير حديث، أو حديث من غير أصول، أو أصول فقه من غير علوم اللغة العربية (نحوا، وصرفا، وبلاغة)، أو عقائد من غير سلوك وتصوف صحيح، فصار الهدف من إنشاء الجامعات وتأسيسها غائبا في ظل غياب النسق العلمي والتكامل المعرفي بين أطياف العلوم وأنواع الفنون، لأن دلالة (الجامعة) تعني جمع الشيء وحصره أي تنظيمه وتنسيقه، فهذه النسقية التكاملية هي الموجودة في المضمون العلمي للجامعات الإسلامية القديمة (القرويين، والأزهر، والزيتونة…) والتي كانت تعبر بشكل نسقي عن نماذج معرفية للعلوم الإسلامية، وتتفاعل مع النظام المجتمعي وقوانينه، وتحتضن كيانه وهويته، وتحافظ على ثوابته وسياساته، وتضمن وجوده واستمراره.
من هنا صار لزاما علينا إعادة النظر والاعتبار في قضية التكامل المعرفي (وحدة المعرفة) داخل الجامعات والمعاهد والكليات، لتجويد العملية التعليمية التعلمية باعتبارها أكبر رهان للتنمية الفردية والمجتمعية، وهي الآلية الأكثر فعالية في تحديد مصير الأمة حاضرها ومستقبلها، والحسم في تقدمها واستقرارها أو في ضعفها وتدهورها.
إن أساس بناء الحضارة الإسلامية هو الدين والعلم، فالدين باعتباره مصدر الإمداد الرباني والضابط للعمل البشري، والعلم باعتباره محرك العقل وأداته في انكشاف الوحي المنظور المتكامل مع حقائق الوحي المسطور، فالتكامل بين الدين بوصفه نصا والعقل بوصفه مستنبطا للعلم من النص، أدى إلى ظهور ونشوء علوم شرعية وغير شرعية كثيرة ومتنوعة، والتي أثرت في بناء الحضارة الإسلامية قديما بناء قويما ومتينا، حتى صارت أمة خير وشهادة كما وصفها الله تعالى في كتابه العزيز: { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}[5]،
فالعلم أساس التكليف والاجتهاد ومصحح الأعمال والأقوال، فالحضارة الإسلامية قامت على المزاوجة بين الدين والعلم وليس على إلغاء أحدهما للآخر، أو الفصل بينهما كما وقع للغرب حينما وجدوا تناقضا صارخا بين الدين المحرف والعلم المجرب، فجعلوا بينهما شرخا كبيرا وأقاموا حربا بينهما حتى أدركوا أنه لا مخرج من هذه الحرب إلا بانتصار العلم وانهزام الدين، باعتبار العلم خصما وحكما، وانتقلت هذه الحرب إلى الأمة الإسلامية حيث صار بعض المنظرين العرب يقلدون الغرب في هذا المخطط جهلا بدينهم وقلة علمهم بحضارتهم، لأنه ليس هناك صراع بين العلم الحقيقي والوحي الإسلامي لا في العصر الحاضر ولا في التراث غابر، إنما تشابهت عليهم الأسباب والمعطيات وتلفقت عليهم الشبه والانتقادات الزائفة، فالإسلام يدعو إلى العلم الصحيح والمنهج السليم لمعرفة أسرار الوجود والكون وتوظيف ذلك في عمارة الأرض وتحقيق الاستخلاف، فالقاعدة المشهورة عند المسلمين أنه لا تعارض بين صحيح المنقول وصريح المعقول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): {وقد بينا في غير هذا الموضع أن الأدلة العقلية والسمعية متلازمة، كل منهم مستلزم صحة الآخر، فالأدلة العقلية تستلزم صدق الرسل فيما أخبروا به، والأدلة السمعية فيها بيان الأداة العقلية التي بها يعرف الله، وتوحيده، وصفاته، وصدق أنبيائه، ولكن من الناس من ظن أن السمعيات ليس فيها عقلي، والعقليات لا تتضمن السمعي…. والعقل الصريح مطابق للسمع الصحيح}[6]، ويقول الغزالي: {فَقَدْ تَنَاطَقَ قَاضِي الْعَقْلِ وَهُوَ الْحَاكِمُ الَّذِي لَا يُعْزَلُ وَلَا يُبَدَّلُ، وَشَاهِدُ الشَّرْعِ وَهُوَ الشَّاهِدُ الْمُزَكَّى الْمُعَدَّلُ}[7].
هنا يطرح سؤال منهجي مفاده: ماذا يجب على طالب العلم من أجل تحقيق تحصيل جيد ومتكامل في ظل هذه الإشكاليات؟
إن المتفرغ لتحصيل العلم وطلبه تعقد عليه الخناصر وتوجه إليه الأنظار باعتباره وريث العلماء في المستقبل، وقائد الأمة في الدين أو الفكر أو السياسة أو الاقتصاد…، فمن الواجب عليه وجوبا عينيا أن يعرف مقامه ويستشعر المسؤولية الملقاة على عاتقه، ويحدد هدفه والوسائل المعينة على بلوغه، بالتزود بالعلم النافع له، مع مراعاة مكانة هذا العلم بين العلوم الأخرى وتقاطعاته معها، ويحاول بكل جهده أن ينهل من معين العلوم المجاورة له، حتى يُكوّن نظرة تكاملية نسقية بين العلوم، فيوظفها بمجموعها في وضعيات شائكة ومعقدة في المجتمع، كما قال الإمام الغزالي: {الوظيفة الخامسة: أن لا يدع طالب العلم فناً من العلوم المحمودة ولا نوعاً من أنواعه إلا وينظر فيه نظراً يطلع به على مقصده وغايته ثم إن ساعده العمر طلب التبحر فيه وإلا اشتغل بالأهم منه واستوفاه وتطرف من البقية فإن العلوم متعاونة وبعضها مرتبط ببعض}[8]، وذهب ابن خلدون إلى إثبات إمكانية التكامل المعرفي إذا تم تبسيط العلوم وتسهيلها بطرق التحمل والتعلم الصالحة والممنهجة، مع تأكيده على أن إتقان الطالب للعلوم الكثيرة اتقانا دقيقا ليس شرطا في حصول الملكة حيث قال رحمه الله: {اعلم أنه مما أضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على غايته كثرة التآليف واختلاف الاصطلاحات في التعليم، وتعدد طرقها، ثم مطالبة المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك، وحينئذ يسلم له منصب التحصيل، فيحتاج المتعلم إلى حفظها كلها أو أكثرها ومراعاة طرقها، ولا يفي عمره بما كتب في صناعة واحدة إذا تجرد لها، فيقع القصور دون رتبة التحصيل…} [9].
فمثلا: فالحد الأدنى الذي يجب على طلبة الشريعة الإسلامية إدراكه من العلوم الكونية ما يحقق معرفة مكونات الكون ومكنوناته العلمية والتنظيمية وأسراره الربانية، من خلال استفراغ الوسع في معرفة مقاصد بعض العلوم الكونية (الفلك، الجغرافيات، الطب، الهندسة، الطبيعيات، الفيزياء والكيمياء…) وأركانها وأقسامها ووظائفها، معرفة سطحية من غير تعمق، وكذا إدراك ارتباط هذه العلوم بعلوم الوحي وتأثرها به، حتى تتكامل لدى الطالب رؤية واضحة للوجود وخالقه، قال تعالى:{ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}[10] وقال سبحانه{ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ}[11] وفي سورة(يس) قال سبحانه وتعالى: {وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ} وقوله:{ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ} وقوله:{ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ} [12].
أما طلبة العلوم الكونية يجب عليهم الاطلاع على بعض علوم الوحي (العقيدة، الفقه، السيرة، تفسير القرآن والحديث…) من أجل تقويم سلوكهم وأفكارهم وتصحيح عقيدتهم وعباداتهم ومعاملاتهم، وفق منهج رباني معزز بالأدلة النقلية (الوحي) والعقلية (الكون)، فيصير عندنا في المجتمع الإسلامي طبيب مؤمن يخشى الله تعالى ويراقبه في معاملاته وفحوصاته المرضية، وسياسي يسهر على حفظ بيضة الإسلام ويضمن حقوق المسلمين ويلبي حاجاتهم، وقاض يحكم بالحق ويأخذ على يد الظالم المعتدي، وفيلسوف ومفكر إسلامي ينتج نظريات تتماشى مع الثقافة الإسلامية ويبتكر أفكارا بديلة عن الإنتاجات الغربية…. وغير ذلك من المهن والصنائع.
فإذا أتقن الطالب التخصص الذي تبحر فيه وقام بالاطلاع على العلوم الأخرى المتعاونة معه، مع حسن الربط بينهما بخيط ناظم ومنهجي متكامل على مستوى التحصيل والتنظير والتطبيق، وبوتقتها في قالب عام يخدم الإسلام والمسلمين ويساعد على تحقق مبدأ الاستخلاف وعمارة الأرض، يمكن القول بكل جرأة وفصاحة أن العملية التعليمية التعلمية أعطت أكلها وبلغت جودتها، وأن زمن التعلم وعمر الطالب لم يهدر عبثا ولم يذهب سدى.
التكامل المعرفي عند سلف الأمة
طغت على العصور الجديدة والأزمنة المتأخرة، مسألة الدعوة إلى التخصص والتبحر في العلم الواحد دون العلوم الأخرى، مع تغييب الجمع والتكامل والتعاون بين العلوم، ولعل مرجع ذلك وسببه لأمرين اثنين: أحدهما ذاتي والآخر موضوعي، فالذاتي متعلق بالإنسان نفسه، بحكم ضعف قوته العقلية والفكرية على استيعاب جميع العلوم والفنون بمختلف دروبها، وكذا قلة زمانه وعمره في استقصائها وطلبها، علاوة على ضعف الإرادة والهمة التي ابتليت بها الأمة الإسلامية مؤخرا، أما الجانب الموضوعي فهو متعلق بطبيعة المعارف والعلوم المدرسة وطرق تدريسها، مع غياب تام للروابط والجسور بين هذه العلوم في المقررات والبرامج والمناهج الدراسية، حيث يشكل ذلك تحديا حقيقيا أمام الطالب يصعب عليه تجاوزه والخروج منه، لأن سجن التخصص يحكمه ويفرض عليه عدم الخروج منه إلى غيره، قال المرعشي: {يغلط بعض الطلبة في ترتيب الفنون والقدر اللائق من السعي لكل فن، فيشرع في بعض الفنون قبل تحصيل ما يتوقف فهمه عليه، وقد لا يهتم لفهم فن تشد الحاجة إليه، ويطيل البحث فيما لا يكثر الاحتياج إليه، وأمثال هذه الترتيبات الردية مدار تنزلهم وعدم وصولهم إلى مقاصدهم.. }[13]، فالأمة تحتاج لمجموعة من العلوم الضرورية من أجل قيام حضارتها وبناء قوتها مثل (علم الاجتماع وعلم النفس وسياسة والاقتصاد والطب والقانون والفلك والفيزياء…) فمثلا إذا غابت معرفة الفقيه المجتهد لبعض هذه العلوم أو قل اطلاعه عليها، قد تصدر منه فتاوى فقهية وآراء علمية، لا تتناسب مع مقتضيات عصره ومتطلبات مجتمعه، خصوصا في الأمور المستجدة الطارئة، قال شهاب الدين القرافي: {وكم يخفى على الفقيه والحاكم، الحق في المسائل الكثيرة بسبب الجهل بالحساب والطب والهندسة، فينبغي لذوي الهمم العالية أن لا يتركوا الاطلاع على العلوم ما أمكنهم… }[14]، وهذا الأمر يدفعنا إلى الكشف والبحث عن فكرة التكامل المعرفي بين علوم الوحي وعلوم الكون، هل كانت حاضرة في فكر علماء الإسلام قديما انطلاقا من نظرتهم للمعرفة عموما وتصنيفهم وترتيبهم للعلوم خصوصا؟
ترتيب العلوم والفنون عند السلف
حقق السلف الصالح من العلماء والمفكرين رحمهم الله عبر التاريخ العلمي الطويل نموذجا رائعا يحتذى به في حرصهم على العلم والمعرفة، انطلاقا من وعيهم بأهمية العلم في بناء حضارة ومجد الأمة من غير تضييع للهوية الإسلامية والمبادئ الربانية، وذلك بالتركيز على العلوم التي تحتاجها الأمة أفرادا وجماعات، تحصيلا وتأليفا وتنظيرا وتدريسا، وترتيبها وتصنيفها بنظرة تكاملية جامعة بين ثوابت الأصالة وتطلعات المعاصرة، فإذا تتبعنا التراث الإسلامي نجد أن العلماء من أمثال الشافعي والغزالي وابن خلدون والدهلوي وغيرهم، يعترفون بالدور الكبير للعقل في التعامل مع الوحي، والذي أدى إلى انبثاق معارف جديدة وتولد علوم وفنون كثيرة، من أمثلة ذلك: علوم القرآن، وعلوم الحديث، وعلم التفسير، والفقه، وأصوله وغير ذلك، وفي المقابل يثبتون أن للإنسان قوة عاقلة لفهم الكون والكشف عن مكنوناته، فيُحصّل بذلك على علم جديد نافع، وهو المعبر عنه بالعلوم العقلية أو التطبيقية أو التجريبية…، فمن خلال تصنيفات العلماء يتضح هذا التفريق بين المقامين، فالإمام الشافعي ” يصنف العلم إلى علم الدين وعلم الدنيا، كما يذهب إلى أن علم الدين بدوره ينقسم إلى علم العامة وعلم الخاصة، علم العامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله، مثل الصلوات الخمس، والصوم في شهر رمضان، وحج البيت إذا استطاعوا، وزكاة في أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر، وما كان في معنى هذا، مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يكفوا عنه ما حرم عليه منه. وأما العلم الخاص فهو ما ينوب العباد من فروع الفرائض، وما يخص به من الأحكام وغيرها، مما ليس فيه نص كتاب ولا نص سنة، وإن كانت في شيء من سنة فإنما هي من أخبار الخاصة، ولا أخبار العامة، أو ما منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا، وأن العلم الخاص من قبيل الفرض الكفائي، إذا قام به المسلمون من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم، وإلا فلا”[15]، وأما الغزالي الذي يعد من كبار الشافعية، فقد فصّل في طبيعة العلوم وترتيبها، وبين أنها ” تنقسم إلى علوم شرعية وغير شرعية والتي ليست بشرعية تنقسم إلى ما هو محمود وإلى ما هو مذموم وإلى ما هو مباح فالمحمود ما يرتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب وذلك ينقسم إلى ما هو فرض كفاية وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة أما فرض الكفاية فهو علم لا يستغني عنه في قوام أمور الدنيا كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان وكالحساب فإنه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث والفلاحة والحياكة والسياسة بل الحجامة والخياطة……. وأما ما يعد فضيلة لا فريضة فالتعمق في دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك مما يستغنى عنه ولكنه يفيد زيادة قوة في القدر المحتاج إليه، وأما المذموم فعلم السحر والطلسمات وعلم الشعوذة والتلبيسات، وأما المباح منه فالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها وتواريخ الأخبار وما يجري مجراه. وأما العلوم الشرعية فهي محمودة كلها ولكن قد يلتبس بها ما يظن أنها شرعية وتكون مذمومة إذا كان فساد في استخدامها”[16]، وأما الشيخ ولي الله الدهلوي فلعه تأثر بتصنيف الإمام الشافعي للعلوم، حيث ذهب إلى” أن العلم قسمان: علم المنقولات وعلم المعقولات، وهو قريب من تصنيف الإمام الغزالي بعلم شرعي وعلم غير شرعي، ومن الجدير بالذكر أن من أهم مساهمات الدهلوي في التصنيف، هو مصطلحه المعروف بالفنون، حيث قسم الفنون إلى “فن آداب المعاش” و “فن تدبير المنزل” و “فن المعاملات” وأدرج في الأخير السياسة وسير الملوك والأعوان”[17].
وبهذا التصنيف الذي أحاط بجسم العلم دون استثناء عند بعض العلماء قديما، ندرك بالملموس مدى حضور نظرية التكامل المعرفي في نظرتهم للعلوم وترتيبها، وهناك إشارات أخرى توحي لنا بأدلة واضحة وقاطعة على تمثل السلف لهذه النظرية على المستوى العلمي تحصيلا وتدريسا وتأليفا، فبرزت نماذج متعددة وأمثلة متنوعة داخل العلوم الشرعية وخارجها.
التكامل الداخلي والخارجي بين العلوم عند السلف
هناك نماذج كثيرة من العلماء الذين حققوا التكامل العلمي على المستوى الفردي في صورة الموسوعية، سواء داخل العلوم الشرعية نفسها، أو بينها وبين العلوم الكونية التجريبية، فعلى الرغم من كثرة العلوم الشرعية وتشعبها إلا أن كثيرا من العلماء حققوا بينها تكاملا علميا منهجيا، وجمعوا أجزائها وضبطوا كلياتها، مثل الإلمام بعلم التفسير والحديث والأصول والفقه والمقاصد واللغة والعقيدة وعلم الكلام والمنطق وغيرها من العلوم والفنون، وظهر ذلك جليا في مصنفاتهم وتناسق أفكارهم، مثل: الإمام ابن حزم وابن تيمية وابن حجر والسبكي والذهبي وابن العربي المالكي والغزالي والسيوطي والطبري وابن القيم وابن خلدون والنووي والأئمة الأربعة، والقائمة طويلة، في حين هناك من جمع بين العلوم الشرعية وعلوم الكونية، وهذا الصنف وجوده لا يستهان به في التراث الإسلامي، ولعل أبرز علماء هذا الصنف الإمام ابن رشد الحفيد الذي جمع بين العلوم الثلاثة (الطب والفقه والفلسفة)، والكندي الذي أنتج إنتاجا متنوعا في المنطق والحساب والطب والهندسة والنجوم والموسيقى والجغرافيا والجدل وعلم النفس والسياسة والأخلاق، وأبو بكر الرازي الذي جمع بين الشريعة والطب، والخوارزمي، وابن سينا، وابن الهيثم، والفارابي…. وغيرهم، وقد فرق العلماء بين التكامل المعرفي في مرحلة التحصيل والتلقي وبين التفرغ للعلم الواحد الذي يجب أن يبذل فيه الطالب جهده ووسعه في الحفظ والفهم والتصنيف، قال ابن قتيبة{من أراد أن يكون عالما فليطلب علما واحد ومن أراد أن يكون أديبا فليتسع في العلوم…}[18]، وقال خالد يحيى لابنه {يا بني خذ من كل علم بحظ، فإنك إن لم تفعل جهلت وإن جهلت شيئا من العلم عاديته لما جهلت، وعزيز علي أن تعادي شيئا من العلم}[19].
خاتمة
إن نظرية التكامل المعرفي تحتاج لعمل دقيق وجهد كبير لتنزيلها على الواقع التعليمي بمختلف مستوياته وشعبه خصوصا على المستوى الجامعي، بتطبيقات بيداغوجية ومنهجية في المناهج والبرامج والمقررات المدرسية، وذلك من أجل العودة إلى ركب الحضارة، والتقدم بين صفوف الأمم، انطلاقا من ضرورة فهم طبيعة العلوم ومقاصدها، والاجتهاد في طلبها وتحصيلها، ثم نشرها والعمل بها، وهذا ما كلف الله به المسلم باعتباره صاحب الرسالة وحامل الأمانة، قال تعالى: { إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا }[20]، وما دام المقال يناقش قضية التكوين العلمي الأكاديمي لدى الطالب الجامعي الذي يعيش انفصاما بين تكوينه العلمي وهويته الدينية، فإن الضوابط المعينة لتحقيق التكامل في التحصيل العلمي ممكنة انطلاقا من استصحاب تجارب سابقة ونماذج معاصرة صالحة للقياس والاقتداء، من غير إخلال بالتخصص، أو عداوة وهمية لبعض العلوم، وذلك عن طريق أسلمة العلوم الكونية وربطها بعلوم الوحي، بردها إلى المصادر الأساسية للمعرفة الإسلامية (القرآن والسنة) والتأصيل لها تأصيلا منهجيا والاستمداد لها استمدادا علميا، وتنقيتها من الأفكار والتجارب التي ليس فيها مصلحة ثابتة أو فائدة عائدة على الإنسان والمجتمع، كما يجب التركيز على إيجاد نظام تعليمي ينبثق من روح الإسلام وبديل للفكر العلماني، من أجل تخريج مواطن صالح يدرك حقيقة أصله، ووجوده ومصيره.
الإحالات
[1] مجاني الأدب في حدائق العرب، لرزق الله بن يعقوب شيخو (المتوفى: 1346هـ) مطبعة الآباء اليسوعيين، بيروت، ج5 ص 245.
[2] كتاب العين للفراهيدي دار ومكتبة الهلال بيروت،ج5 ص378. والقاموس المحيط لفيروز آبادي مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط:8، ج1 ص 1054. ولسان العرب لابن منظور، دار صادر، بيروت، ط3، ج 11 ص598.
[3] سورة المائدة الآية: 3
[4] سورة النحل، الآية: 78.
[5] سورة ال عمران، الآية: 110
[6] درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـ) المكتبة الشاملة، ج 8 ص 24 و25.
[7] المستصفى، للإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ)، دار الكتب العلمية،ط:1، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي،ج1 ص3.
[8] إحياء علوم الدين للإمام أبو حامد الغزالي، دار المعرفة – بيروت ج:1 ص:51 و52.
[9] المقدمة لابن خلدون، تحقيق علي عبد الواحد وافي، القاهرة، نهضة مصر للطباعة ط 3، ج1 ص339
[10] سورة العنكبوت، الآية: 20.
[11] سورة الغاشية، الآيات:من17 إلى 21.
[12] سورة يس، الآيات: من 33 إلى 44.
[13] ترتيب العلوم للمرعشي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط1-88، ص:82.
[14] أنوار البروق في أنواء الفروق، عالم الكتاب، بيروت، بدون تاريخ، ج4 ص11.
[15] ينظر: الرسالة لمحمد بن إدريس الشافعي دار الكتاب العلمية بيروت تحقيق: أحمد شاكر ج1 ص357 فما بعد.
[16] ينظر: إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد الغزالي دار المعرفة بيروت ج1ص13 فما بعد.
[17] ينظر: حجة الله البالغة أحمد بن عبد الرحيم المعروف بشاه ولي الله الدهلوي، دار كتب الحديثة القاهرة، تحقيق: سيد سابق ص83، فما بعد.
[18] نفس المرجع السابق، ص247.
[19] جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر القرطبي (المتوفى: 463هـ)، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط:1، ج1ص523.
[20] سورة الأحزاب، الآية:72.
 تعليم جديد أخبار و أفكار تقنيات التعليم
تعليم جديد أخبار و أفكار تقنيات التعليم








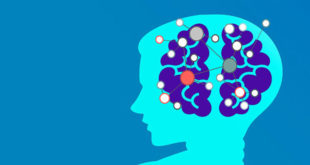
مشكورين
بارك الله الباحث ياسين على تدوينته القيمة، والشكر للقائمين على الصفحة ايضا.