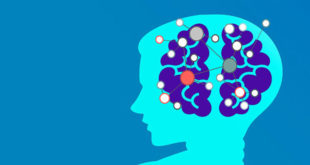ينم الخطأ في البيداغوجيات التقليدية – في الغالب – عن نقص أو تحريف في المعرفة ، كما و يعبر عن الفشل و الكسل و العجز ، لذلك وضع الخطأ في خانة المحرم الذي لا يجب ارتكابه أو الإدلاء به ، فنجد الكثير من التلاميذ يتوجسون من الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها الأستاذ خوفا من الوقوع في الخطأ ، لأن الإجابة الخاطئة ستجني عليهم العقاب و السخرية و التعيير، إما لأن الأستاذ صارم تجاه مرتكبي الأخطاء ، أو أن التلاميذ ينتظرون أي إجابة غير مستحسنة ليسخروا من صاحبها ، فيتحول الفضاء الدراسي إلى تكنة عسكرية الخطأ فيها ممنوع ، لأنه خروج عن القاعدة و جنوح عن الضوابط و ابتعاد عن الحلول، و ينتج عن ذلك ردع المتعلم و إقصاؤه ، و تقييده بالصحيح الصائب ، فالجواب الصحيح يدل على النباهة و الحذاقة و يميز المتعلم المجتهد عن المتعلم الكسول ، إنه ابداع و إنتاج، بينما الخاطئ يحيل إلى الزلل و والارتجاج. إن هذا التحديد هو الذي يستبطنه المعلمون و يدرسون طبقا له، فينساقون وراء المحتوى الموضوع، و كل إجابة هي بالضرورة سلطة للمحتوى ، ولا سبيل للمتعلم إلا أن يذعن لها ، لذلك نجد بعض المتعلمين يلوذون إلى الحفظ الغزير غافلين عن تطوير الجوانب الشخصية لديهم ، على أن هذا الجانب المنسي في العملية التربوية يندرج ضمن المقاربة بالكفايات، المقاربة التي تضع نصب عينها المتعلم، و تنظر للخطأ على أنه جزء من التعلم ، و ما الخطأ فيها إلا محاولة للتفكير ، و هذا الأخير اجتهاد و سعي إلى الحقيقة ، و يكون فيها دور المعلم مقصورا على مجرد التأطير و التوجيه ، بما يمنح له أحقية إرشاد المتعلم المخطئ إلى ما هو صائب انطلاقا من قدرة المتعلم نفسه على استئصال الخطأ و تصحيحه ، و لا يمكن أن يحصل هذا دون أن نشخص الخطأ و نحدد أبعاده، و نفس هذه الأبعاد هي الكفيلة بتنقيحه أو إصلاحه ، و بناء على ذلك نستطيع أن نأسس لطرائق و أساليب للتعامل العلمي و الدقيق مع الخطأ بدل الأحكام الجوفاء التي تتهم المتعلم بالفشل و العجز ، فالمقتضى الأول الذي يجب أن ننطلق منه هو الفهم ، و من الفهم يتولد التفهم. إننا نريد أن نفهم خلفيات الخطأ ، و منها نتفهم المخطئ ، فما هي هذه الخلفيات؟ و ما أبعاد الخطأ؟ و كيف يمكن استثمار هذا الخطأ بطريقة تقودنا إلى تفهمه؟
ينضوي مفهوم الخطأ على الأرجح تحت إمرة ثقافية ، تفرض التحديدات و الأشكال التي يتخذها ، بمعنى أن معياريته تتعدد باختلاف الثقافات ، فما هو خطأ في ثقافة ليس بالضرورة يعتبر خطأ في ثقافة أخرى ، و مردنا هنا هو أن نبين مدى نسبية المفهوم ، و من هذه النسبية نشفع لموضوعنا أن يكتسي ثوب النسبية المطلقة ، فنخلعها على الحكم التربوي كذلك الذي يصدره المعلم في حق متعلم أدلى بإجابة خاطئة ، إن هذه الإجابة يمكن أن تكون صحيحة في مقام و مقال آخر مع معلم آخر. لهذا فالحكم نفسه معرض لهذه النسبية.
لكن يمكننا أن ننتزع الخطأ من قبضة الثقافة لنسلمه إلى تدقيق علمي بيداغوجي، فالخطأ بيداغوجيا كما يحدده الدكتور جميل حمداوي هو :” إجابة المتعلم المتعثرة عن سؤال معين ، أو هو ذلك السلوك الذي يقوم به التلميذ و لا يكون متلائما مع المطلوب أو تعليمات الوضعية السياقية ” [1]. إذن، و حسب هذا التحديد ، فالخطأ هو انزياح و انحراف عن المسار الذي يسلكه المعلم أثناء إلقاءه للدرس التعليمي ، و إخفاق المتعلم عن التوصل إلى حل يتوافق و المطلوب في العلمية أو الوضعية التربوية . و قد يرجع هذا الخطأ إلى عدة أسباب هي التي سميناها بالأبعاد أو الخلفيات ، و لكن بمعنى أشمل يكتسي طابعا علميا كما سنرى ، من بينها الالتباس التي يغطي السؤال فينتج عنه سوء فهم من قبل المتعلم ، أو قد يكون ناجما عن اضطراب و خلل معرفي يخلق لصاحبه فوضى ذهنية لا يقدر معها أن يميز بين الصائب و الخاطئ.
و يجب أولا أن نميز بين الخطأ و الغلط، لكي نحذف أي ارتباك قد يحصل نتيجة للخلط بين هذين المفهومين ، و يمكن أن نحسم الفصل بينهما إذا جاز ذلك انطلاقا من القول أن الغلط يرتبط بالعملية المعرفية ، أما الخطأ فيتعلق بالعملية التعلمية ، بمعنى أن الغلط ينتج عن اعتقاد المتعلم أن ما يقدمه من معرفة يخلو من أي خطأ في حين أنه في الحقيقة يعج بالأخطاء ، بيد أن الغلط لا يكون خطأ إلا إذا ارتبط بالسياق أو تخللته أغلاط لغوية ، فحين يطرح الأستاذ سؤالا عن ماهية الشخص و يجيب تلميذ على أن الشخص هو الإنسان ، هذا الجواب صحيح في الحقيقة لأن الشخص إنسان بالفعل ، إلا أنه في السياق الفلسفي الأمر يختلف شيئا ما ، حيث التدقيق المفاهيمي الصارم ، لذلك سيعتبر الأستاذ جواب المتعلم غلطا و ليس خطأ ، فالخطأ لا يقبل السياقات ، أي أنه مطلق ، كأن يجيب التلميذ بأن الشخص هو حيوان و يكف عن إتمام الجواب للسبب الذي ذكرناه آنفا ، فهذا خطأ بإطلاق سواء في الفلسفة أو في أي مجال معرفي آخر ، لأنه قد يكون مستمدا من تمثلات معينة أو من معرفته الناقصة حول تحديد أرسطو مثلا لهذا المفهوم بالحيوان العاقل ، فلو أتم هذا التحديد لاعتبر جوابه صحيحا، لذلك وجب اتباع خطوات ديداكتيكية معه من أجل أن يتلمس خطأه و يعالجه بنفسه. و لنا في هذا الموضوع تكملة مع أبعاد الأخطاء.
يتحول الخطأ إلى بيداغوجيا حين يتم استغلاله و استثماره في العملية التربوية، و من ثمة الاحتفاظ به كركيزة أساسية لبناء معارف صائبة تخلو من الخطأ، فبيداغوجيا الخطأ إذن تعتمد على الخطأ لتقدير النقائص و الهفوات التي تعتري الدرس الفلسفي بغية الاشتغال على تعديلها و سدها ، إنها ” ترتكز على افتراض صعوبات ديداكتيكية ، تواجه المتعلم أثناء القيام بتطبيق التعليمات المعطاة له ضمن نشاط تعليمي ميعن، و تتجه في أحد مستوياتها إلى الوقوف عند أسباب الخطأ ، سواء من منطلق التصور القبلي حوله ، و المرتبط أساسا بالمعرفة المتراكمة سابقا ، أو على مستوى لحظة التعليم و خلال السيرورة التعليمية “[2] .
و لما كان الخطأ منبعثا من الصعوبات الديداكتيكية فإنه مكون قد يشترك فيه مصدران : المعلم و المتعلم، فيحصل أن يكون المعلم سببا في تعثر التلميذ في الإجابة عن سؤال معين و هذا لعدة اعتبارات، كما و يحصل أن يكون التلميذ نفسه منبع المشكل، و هو مشكل قبلي يمكن التخلص منه، و معنى القبلية هنا هو أن التلميذ بما هو منتوج اجتماعي و نفسي يستبطن هابيتوسات ( سجيات ) تتحكم في إجاباته و فهمه للسؤال، لذلك فهو لا يلام إذا أخطأ ، و حتى إن فعل فيمكن أن نضفي على خطئه طابعا ابستيمولوجيا نستطيع بموجبه أن نمهد لمعرفة يكون عمادها الخطأ، و من هنا نستشف أربعة أبعاد للخطأ : بعد ابستيمولوجي، بعد سيكولوجي، بعد سوسيولوجي، بعد ديداكتيكي.
1 – الخطأ ابستمولوجيا : حينما يكون التعثر سببا في النهوض
غاستون باشلار نموذجا:
يعتبر الخطأ في الابستيمولوجيا مكونا أساسيا في بناء المعرفة العلمية الحقة باعتبارها معرفة قابلة للتجدد و التغير إذا أبانت عن مكمن العائق فيها ، لذلك نجد غاستون باشلار أحد نقاد العلم البارزين يدعو إلى ضرورة الاعتناء بالخطأ ، فهو البؤرة التي تنفجر منها الحقائق العلمية ، إن تاريخ العلم كما يقول باشلار هو تاريخ تصحيح أخطاء العلم ، بحيث لا يمكن أن نعرف إلا ضد معرفة سابقة [3]، و هذا يحيلنا إلى فكرة مهمة يجب التنويه بها ، هي أن الخطأ لا ينبجس من عدم و خواء ، بل إنه ينشأ عن قناعات قبلية متأصلة و متجذرة في عقله بحيث توجه كل جواب يدلي به ، و حسب هذا المنطق ، فالمتعلم ممتلئ بأفكار سابقة قد تتعارض مع الوضعية المطلوب حلها ، إنه مكدس بالآراء الشائعة المتداولة التي تترجم الرغبات إلى معارف . و من هنا يمكن أن نعذر التلميذ إذا أخطأ ، و يصح أن نقول أن أخطاءه لا تعود إليه بالذات بل إلى تاريخه الشخصي الذي راكم فيه مجموعة من المعتقدات و الأفكار حول مواضيع متعددة ، فتكبله و تمنعه عن الانعتاق منها ، الشيء الذي يتكفل به المعلم . فمثلا : في درس السياسة تحدث الأستاذ عن الديموقراطية و سأل عن معناها ، أجاب أحد المتعلمين على أنها الشورى ، جوابه هذا يفضح منبعه ، كون الديموقراطية مفهوما فلسفيا و سياسيا، أما الشورى فهو مصطلح ديني، إذن فالمتعلم قد تأثر بالدين لدرجة أنه يفصح على أن الإسلام كان أول من نادى بالديموقراطية. صحيح أن هذا خطأ، إلا أنه يعبر عن شيء ما، لذلك يجب على الأستاذ أن ينبش عن هذا الشيء و يستفسر عن دلالات الشورى عند التلميذ و يوافق بينهما و بين جوانب الديموقراطية لما لهما من أوجه اتفاق، أو قد يلجأ الأستاذ إلى هدم اعتقاد التلميذ و يؤسس على أنقاضه التمييز أو التحديد الصحيح للديموقراطية.
يشهد التاريخ العلمي نفسه على أن النظريات العلمية الصلدة و المتينة قد قامت على أخطاء، كما و نجد في تاريخ الفلسفة تلميذا ينتقد أخطاء أستاذه و يبني عليها ، و مثال أفلاطون الأستاذ و أرسطو التلميذ خير دليل على ذلك ، حين قال الأخير أنه يحب أستاذه و لكنه يفضل الحقيقة عليه ، إن الخطأ إذن في الابستيمولوجيا لا يقدح ، بل يمدح .
2 – الخطأ سيكولوجيا : قدرات المتعلم هي التي تحكم
جون بياجي نموذجا :
يبقى أن نقر بتباين مستويات المتعلمين كي نقتحم بعدا آخر من أبعاد الخطأ و هو البعد السيكولوجي ، فالبنية الداخلية لكل متعلم تقوم على خصوصية دفينة يصعب تلمسها بسبب تستر المتعلم و كتمانه لما يكتنفه من نقص معرفي أو حتى من ضعف في الفهم ، فبعض المتعلمين من جهة لا يقدرون على استيعاب المعارف التي تبدو لهم غامضة أو معقدة لا تتناغم مع مستوى نضجهم المعرفي و قدرته العقلية و الانفعالية، و من جهة أخرى بعضهم يختلف في زمن التحاقه بالتعلم. كما أن صنفا من المتعلمين يعاني من مشاكل نفسية و عصبية . و بغض النظر عن كل هذه الجوانب ، فإن السيكولوجيا تقر كذلك أنه ليس كل خطأ يمكن اعتباره سيئا ، فهناك أنواع من الأخطاء لابد من ارتكابها حتى نتعلم و نكتسب الخبرة ، و هي الأخطاء التي نقع فيها حين نبدأ بتعلم سلوك نجهله ، مثال ذلك تعلم المشي ، فالطفل الصغير حين يحاول أن يمشي فإنه يتعثر و يسقط ثم يحاول مرة أخرى حتى يتمكن من تعلم المشي ، إن الخطأ بهذا المعنى فطرة إنسانية ناجمة عن الجهل بشيء و محاولة تعلمه.
نسعين هنا بأحد أعاظم علماء النفس جون بياجي ، حيث أضفى هذا الأخير طابعا إيجابيا على الخطأ ، فلم يعد الخطأ عنده نقيصة أو فشلا و إخفاقا ، بل هو ثمرة إنتاج و إبداع ، إنه شرط التعلم ، لأن الذي لا يتعلم لا يخطئ ، أما الذي يطلب العلم فبالضرورة يمر بكبوات و سقطات لا محيد له منها ، و يؤسس عليها خبرته و تجربته . فالتلميذ عندما يخطئ فإنه يفكر ، و بما أنه يفكر ، إّن هو يبحث عن الحل ، و هذا مرمى الحديث ، و يتوجب على الأستاذ أن يتقبل الخطأ و يقوم بتقريظه على أنه محاولة جيدة ، و يتداوله معه حتى يتوصل إلى صيغة توافق ترضي المتعلم .
و بما أننا ندور في فلك سيكولوجية النمو عند بياجي، نضيف أن القدرات العقلية للمتعلم ترتبط بمستوى النمو عنده ، فبعض التلاميذ لم يصلوا إلى مستوى عقلي مناسب يخول لهم تدقيق إجاباتهم ، إذ أن مستوى تلميذ يدرس في الإعدادي ليس هو المستوى نفسه لتلميذ يدرس في الثانوي ، و نضرب مثالا بسيطا هنا لكي نبين هذه الفكرة : عندما يحاول الأستاذ أن يشرح نظرية المثل لأفلاطون لتلامذته لاحظ أن بعضهم لم يستطع الانتباه ، أما البعض الآخر فوجد صعوبة بالغة في فهم هذه النظرية ، و ذلك لسبب بسيط لأنها نظرية غارقة في التجريد و تقتضي عقلا نسقيا منظما و فلسفيا لكي يفهمها ، اما التلميذ البسيط فلم يصل إلى هذا المستوى أبدا ، فليس من الغريب أن يتدخل و يقول أن نظيرة المثل هي الجنة . و بالتالي و من أجل أن يوضح الأستاذ الأفكار الفلسفية يعتمد أسلوب تقديم أمثلة من الواقع الفعلي الذي يعيشون فيه ، الواقع المتجسد الذي عاينوه بأنفسهم ، و صحيح بأن المرحلة المجردة تبدأ من سن الثانية عشرة ، و لكن التجريد الفلسفي يحتاج إلى منتهى الحذاقة ، هو تجريد سامي عن كل تجريد ، و ما ينطبق على الفلسفة ينطبق على الرياضيات كذلك .
تنذر السيكولوجيا بآفة ممارسة الضغط على التلميذ ، ذلك الضغط الي يدفعه إلى ارتكاب الأخطاء ، فحينما يفرض الأستاذ واجبات كثيرة و يلقيها على عاتق التلميذ ، فإنه يخلق التوتر لديهم ، و من الطبيعي أن يسفر التوتر عن خطأ .
3 – الخطأ سوسيولوجيا : صناعة الأخطاء قبليا
بازل برنشتاين و الأخطاء اللغوية نموذجا
لا يمكن أن ننكر الدور الذي يلعبه المجتمع في تكوين و تهييئ الفرد ليصبح كائنا اجتماعيا ، معنى ذلك أن يكون الفرد متشربا لمجموعة من الأنماط الفكرية الجاهزة و المعتقدات و القناعات السائدة داخل مجتمع معين ، إنه إذن منتوج اجتماعي ، و مرآة تعكس صورة المجتمع بأكمله . و من هذا المنظور نستطيع أن نفهم الخطأ من زاوية اجتماعية تمنح لهذا الفعل المذموم أفقا يصفح عن الفرد و يتوجه للمجتمع باعتباره مصنع الأخطاء و ورشة لتجهيز الأغلاط اللغوية حيث تتبدى فيها بوضوح الفوارق الاجتماعية ، فالخطأ في مرمى السوسيولوجيا في آخر المطاف يرتد إلى عوالم داخلية مطمورة تتجذر في المجتمع ، و بما أن المتعلم قبل أن يلج المدرسة قد كان تحت ذمة أسرته ، فمن الطبيعي أن يحمل هذا المتعلم معه كل ما تربى عليه من أخلاق أو لغة أو أفعال ، و تضطلع المدرسة بدور تعزيز هذه التربية أو تشذيبها أو عقد نوع من الانسجام . لذلك سيكون مثار حديثنا في البعد السوسيولوجي أعم قليلا عن الأبعاد الأخرى ، و سنخوض فيه تجربة الحفر في الأعماق و تقصي المتعلم في مرحلتين أساسيتين في نشأة تاريخه الشخصي ، مرحلة ما قبل الخطأ أو كما يتفضل علينا تسميتها بمرحلة صناعة الأخطاء و التي تتم داخل ردهة الأسرة، وصولا إلى مرحلة ظهور الخطأ ، هذه المرحلة ترتبط بالحجرة الدراسية ، ساعين إلى الإجابة عن سؤال إشكالي صارخ ، يتعلق بالصلة الجامعة بين الأسرة كمجتمع ثقافي و المدرسة كمجتمع معرفي ؟ و كيف يتمزق المتعلم حين يتجاذبه الطرفان ؟ ، و إنا نعتبرها السبيل الوحيد لبلوغ درجة التفهم عبر الفهم العلمي لما يروج و يجول داخل هذه الدائرة الواسعة التي نسميها مجتمعا .
فالمرحلة الأولى هي التي يكون فيها المتعلم في حضن المجتمع ، يتشبع فيه بمختلف التمثلات و المعتقدات و الآراء و القيم و المعايير… هذا الإطار النظري لا يمكن أن يفهم إلا باستقاء أمثلة في الواقع نسوقها انطلاقا من الوسط الاجتماعي الذي ترعرع فيه المتعلم و اكتسب منه تلك المكونات التي عرضناها ، حيث أن القانون الاجتماعي علميا يقر بوجود فروقات اجتماعية صارخة تحتويها المدرسة و تحاول أن تخمد شرارتها ، فالمتعلم الذي ينحدر من وسط قروي ليس هو نفسه الذي ينحدر من وسط حضري ، فالأول لم يحتك مع مظاهر التحضر ، أما الثاني فقد عاين هذه المظاهر عن كثب ، فضلا عن الخلفية الأسرية التي ينتمي إليها كل واحد منهم ، فالأسرة التي تتمتع بمستوى معرفي و ثقافي معين من الطبيعي أن تعادي أبناءها بمستواها ، و العكس ينطبق على الأسرة التي تفتقد ذلك المستوى . إذن فالأطفال الذين ينشؤون في مهادات اجتماعية مختلفة يطورون في مراحل مبكرة من حياتهم رموزا مختلفة أو أشكالا من الكلام تترك آثارا على تجربتهم المدرسية اللاحقة. هذه الرموز لا تعني المفردات أو المهارات الشفوية ، بل الفوارق في صيغ التعبير و أساليب استخدام اللغة في أوساط الأطفال الفقراء مقابل الأطفال الأغنياء . إن حديث أطفال الطبقة الكادحة تمثل” رموزا مقيدة ” ، أي وجوها لاستخدام اللغة تنطوي على افتراضات غير معلنة يتوقع المتحدثون من الآخرين أن يكونوا على علم بها، إن الخطأ بهذا المعنى ليس معرفيا بل هو سوسيولوجي، لأنه خطأ قبلي مرتبط بالمكتسبات الاجتماعية، فالتلاميذ من الطبقة الفقيرة يتطبعون بما يسميه عالم الاجتماع البريطاني بازل برنشتاين ب “الرموز المقيدة “، في حين أن المتعلمين من الطبقة المتوسطة يتمتعون ب ” رموز مفصلة ” ، أي أسلوب الحديث الذي تتحدد فيه معاني الكلمات المستخدمة لتطابق الوضع في تلك اللحظة . و خلافا لما يقوم به أفراد الطبقة العاملة حينما يوقعون العقاب أو الثواب مباشرة دونما شرح للأسباب و البواعث ، فإن الأهل من الطبقة الوسطى يسهبون في حالة مماثلة في تعداد المبررات و المسوغات لتصرفاتهم تجاه أطفالهم . فالأطفال الذين يكتسبون الرموز المفصلة يكونون الأقدر على التعامل مع متطلبات التعليم من نظرائهم الذين تلقنوا الرموز المقيدة مما ييسر دخول أبناء الطبقة الوسطى و تعايشهم مع بيئة المدرسة[4] .
و لكي ننتقل من الفهم العلمي إلى التفهم الانساني أقترح مجموعة من المحددات التي يرتبط فيها استخدام الرموز المقيدة بالحد من فرص التعليم التعليمية:
1 ) ربما يتلقى الطفل استجابة محدودة على ما يثيره في البيت من تساؤلات ، مما يضيق من مداركه المعرفية، و يكبح فضوله لمعرفة ما يدور في العالم الخارجي.
2 ) سيكون من الصعب على الطفل أن يستجيب لعبارات اللغة المجردة و غير المشحونة بالعاطفة أو التجاوب مع التعليمات التي تدعو إلى الالتزام بالانضباط المدرسي .
3 ) سيعاني الطفل أو المتعلم بعض الصعوبة في تعلم الأفكار المجردة و التمييز بين المفاهيم المختلفة القابلة للتعميم من خلال التمارين و التدريبات التي يشارك فيها في المدرسة ، و سبق و أن أشرنا إلى هذه الصعوبة في الشق السيكولوجي ، و هي تنطبق أساسا على المواد التي تعتمد الدقة و المنطق و التجريد كالفلسفة و الرياضيات .
4 ) قد يكون ما يتحدث به المدرسون أمرا غير مفهوم لدى الطفل ، لأنهم يستخدمون لغة غير مألوفة لم يعتد عليها . من هنا ، فإن الطفل قد يفسر عبارات المدرسين بالطريقة التي تحلو له ، و يجانب فيها الصواب ، و قد تكون مخالفة لما قصده المدرس ، من هذا المنطلق نعرج عن الخطأ الذي يرتبط بالمتعلم بمختلف أبعاده نحو الخطأ الناجم عن الديداكتيك الذي يستعمله المدرس ، فقد يكون هذا الأخير مثلا يستعمل التشبيهات و الاستعارات و كل ما يماثل اللغة المبهمة أو المبدعة احيانا الغارقة في الخيال المسروح و الأسلوب الرهف في الحديث ، صحيح أن ذلك له أثر في نفوس المتعلمين لكنه ينسف بقدرتهم على الفهم و الاستيعاب . لنضيف على ذلك أن المدرس قد يطرح أسئلة غامضة أو مركبة و معقدة تستعسر على المتعلم الإجابة عليها . لذلك يجب أن نتفهم هذه الأمور ، هذا التفهم الذي لا يمكن أن يتحقق ، و نؤكد على ذلك ، إلا بالفهم المتبصر[5] .
خاتمة :
لقد سعينا في مختلف أطوار هذا المقال إلى عرض الأبعاد و الخلفيات التي تدفع الإنسان إلى الخطأ ، حددناها في أربع، سيكولوجية و ابستيمولوجية و سوسيولوجية و ديداكتيكية ، تخول لنا كلها أن نصل إلى فهم بمجمل العوامل القبلية لنشوء الخطأ سواء داخل الفصل أو خارجه . هذا الفهم يجعلنا نتخلص من الانطواء و الانغلاق على فكرة سابقة تذمم الخطأ، و ننفذ إلى آفاق جديد تقرظ و تمدح الخطأ كشرط لحصول التعلم، الشيء الذي يقودنا إلى تفهم المتعلم المخطئ و محاولة إرشاده إلى ما هو صحيح ، و هذا لا يجب ان يتخذ شكلا قسريا ، و إنما شكلا تحبيذيا ، لأن الخطأ الإيجابي يظهر لمرتكبه و يدركه ، و إذا أدركه فسيسعى إلى تجاوزه ، فالخطأ هو قنطرة عبور من ضفة الكسل و الفشل إلى ضفة المعرفة و العلم ، إنه محاولة دؤوبة لحصاد المعرفة ، هو فضول و تفكير ، و منه يمكن أن نقول أن استثمار الأخطاء كبيداغوجيا كفيل بتنمية مهارات التحليل و النقد و تشجيع البحث. و كما يقول فان خوخ: ” النجاح في بعض الأحيان، يكون نتيجة لسلسلة كاملة من الأخطاء “.
لائحة المصادر و المراجع :
1 . اسليماني ( العربي ) ، المعين في التربية ، من المطبعة و الوراقة الوطنية ،مراكش ، طبعة 2 ، ماي 2021 .
2 . باشلار ( غاستون ) ، تكوين العقل العلمي ، ترجمة خليل أحمد خليل ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، بيروت ، ط 2 ، 1982
3 . حمداوي( جميل ) ، بيداغوجيا الأخطاء ، مكتبة المثقف ، 2015
4 . غدنز ( أنتوني ) ، علم الاجتماع ، ترجمة الدكتور فايز الصباغ ، مركز دراسات الوحدة العربية ، المنظمة العربية للترجمة ، بيروت ، ط 1 ، 2005
حمداوي( جميل ) ، بيداغوجيا الأخطاء ، مكتبة المثقف ، 2015 ، ص 10[1]
د. اسليماني ( العربي ) ، المعين في التربية ، من المطبعة و الوراقة الوطنية ، طبعة 2 ، ماي 2021 ، مراكش. ص 332[2]
[3] باشلار ( غاستون ) ، تكوين العقل العلمي ، ترجمة خليل أحمد خليل ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، بيروت ، ط 2 ، 1982 ، ص 13
[4] غدنز ( أنتوني ) ، علم الاجتماع ، ترجمة الدكتور فايز الصباغ ، مركز دراسات الوحدة العربية ، المنظمة العربية للترجمة ، بيروت ، ط 1 ، 2005 ، ص 558
 تعليم جديد أخبار و أفكار تقنيات التعليم
تعليم جديد أخبار و أفكار تقنيات التعليم