هذا المقال هو المقال الثاني من دراسة حول توظيف مفهوم تربية المستقبل عند إدجار موران في منهج التربية الإسلامية للكاتب د/ عبد المقصود سالم جعفر. اضغطوا هنا لقراءة المقال الأول.
تمهيد
يُعد إدجار موران من أبرز المفكرين الذين اهتموا بدراسة التحديات التي تواجه التربية اليوم، ولقد عالج ذلك في كتابه تربية المستقبل، وذلك إثر تكليف من اليونسكو. وقد عد سبع مثالب تواجهها التربية حاليًا ومستقبلا. وفيما يلي نستعرض خمسا من سمات تربية المستقبل: تنقية المعرفة، وإصلاح طرق التفكير، وتعليم الشرط الإنساني، وتعليم الهوية الأرضية، وتعليم الفهم الإنساني.
1- تنقية المعرفة
إن السمة الأولى من سمات تربية المستقبل هي التأكيد على أن المعرفة ليست يقينية. فالمعرفة ليست منزهة عن الخطأ، فلم يستطع الإنسان يوماً ما الوقوف على قمة مستوى اليقين في المعرفة، وذلك لأنه بطبيعته البشرية يخطئ ويصيب، ولأن عقله لم يعط قدرة مطلقة للمعرفة، إضافة لعدم قدرة عقل الإنسان على الوصول لهذا المستوى من اليقين، فإنه لم يُعط القدرة على الإحاطة بالمعارف على مدار الزمان والمكان. ولقد سبق لماركس وانجلز أن وضحا، في الأيديولوجيةالألمانية، كيف أن البشر شيدوا على الدوام تصورات خاطئة حول أنفسهم وحول ما يفعلونه وما يعتقدون أن من واجبهم فعله إزاء عالمهم. ولكن لا ماركس ولا انجلز استطاعا الانفلات من قبضة هذه الأخطاء.” لذلك كان لزاماً على التربية أن تؤكد هذا المعنى في نفوس المتعلمين والمعلمين، وأن المعرفة البشرية ليست منزهة عن الخطأ.
فالمعرفة سواء كانت أفكارا أو أشياء أو كلمات تلتقطها حواس الإنسان، وتعيد بناءها، أو ترجمتها داخل الإنسان، تبقى مُعطى خارجيا من المعلومات عن الأشياء أو قوانينها أو أسمائها وصفاتها اللغوية؛ وهي:
– المعرفة الحسية، وهي معارف بسيطة تتعلق بظواهر الأشياء الخارجية.
– والمعرفة العقلية، وهي معارف عميقة تتعلق بقوانين الأشياء وخواصها.
– والمعرفة الكلامية، وهي معارف بيانية متعلقة بأسماء الأشياء وأسماء الأفعال -المصادر- التي تقع من الأشياء وعليها.
وبهذا فذات الإنسان المُستقبلة لهذه المعرفة -تؤثر وتتأثر- في بناء هذه الأخيرة، وهذا يفسر الأخطاء التي يقع فيها الإنسان في إنتاج المعرفة، كونها -في شكل كلمات وأفكار ونظريات- ثمرة ترجمة، أو إعادة بناء عبر وسائل اللغة، وأن الفكر يقوي لا محالة من فرص الوقوع في الخطأ. يضاف إلى ذلك أن المعرفة سواء على مستوى الترجمة أو على مستوى إعادة البناء تشتمل على التأويل، مما يسرب إمكانية الوقوع في الخطأ داخل ذاتية الذات العارفة، وداخل رؤيتها للعالم، وداخل مبادئها المعرفية، ويفسر الأخطاء العديدة في قلب ما يتم بناؤه من تصورات وأفكار، على الرغم مما قد نمارسه من مراقبة عقلانية على عملية ومسار إنتاج المعرفة. وأخيراً، هناك مشكل إسقاط رغباتنا ومخاوفنا والاختلالات العقلية التي تحبل بها انفعالاتنا وتضاعف من احتمالات الوقوع في الخطأ.
ومن ثم، فعلى التربية أن تكشف مصادر أخطاء وأوهام المعرفة، مثل الأخطاء الذهنية، وأخطاء العقل؛ فأما الأخطاء الذهنية، فإن الوجدان يلعب دوراً كبيراً في تطوير أو وأد المعرفة، فتطور الذكاء داخل عالم الثدييات، وخاصة داخل العالم الإنساني، غير منفصل عن تطور الوجدان، فهناك على الدوام تواشج قوي بين العقل والوجدان. فقد يؤثر ضعف في الوجدان بشكل سلبي على ملكة العقل، وقد يشلها تماماً، وقد يؤدي إضعاف القدرات العاطفية إلى سلوكيات لا عقلانية، ومن جهة أخرى بإمكان القدرة على الانفعال أن تشكل حافزاً ضرورياً للقيام بسلوكيات عقلانية. ويفرق موران بين العقل والوجدان من حيث التكوين، وغلبة الوجدان على العقل.
أما أخطاء العقل، فكما سبق ذكره من أن عمل العقل هو ترجمة، أو إعادة بناء للصور والأشياء والكلمات، وخروج العقل عن وظيفته هذه إما بتحميله إنتاج الحقائق، أو وضع المعايير الأخلاقية، فإنه يعتبر انحرافا عن وظيفة العقل والعقلانية الحقيقية، “العقلانية الحقيقية هي التي تعي جيداً حدود المنطق والنزعة الحتمية والنزعة الآلية، إنها تعلم جيداً أن العقل الإنساني لا يمكنه معرفة كل شيء.” كما أن العقلانية ليست حكراً على أمة دون سائر الأمم، والعقلانية ليست حكراً على الحضارة الغربية دون سائر الحضارات، فلقد اعتقد الغرب الأوروبي لمدة طويلة أنه الحامل الوحيد للعقلانية رامياً بالأخطاء والأوهام والتخلف إلى الثقافات الأخرى، فيحكم على الثقافات بمدى انخراطها في مسارات الإنجازات التكنولوجية، والحال أننا نجد في كل مجتمع، بما في ذلك المجتمع البدائي، حضوراً قوياً للعقلانية في طريقة صياغة الأدوات وتقنيات الصيد ومعرفة النباتات والحيوانات والمحيط بموازاة الأسطورة والسحر والدين. ومجتمعاتنا الغربية ذاتها حبلى بالأساطير والسحر والدين بما في ذلك أسطورة العقل الموهوب، وأسطورة عبادة التقدم، إننا نكون عقلانيين بشكل حقيقي عندما نعترف بوجود التبرير العقلاني في قلب عقلانيتنا، وبوجود أساطيرنا الخاصة، ومنها أسطورة القوة الخارقة للعقل، وأسطورة التقدم الحتمي.
وبمقابلة ما ذكره موران مع مفهوم المنهج، يتضح أن مصدر المعرفة في تعريف موران هو العقل الإنساني، فعنده أن العقل الإنساني هو المنتج لها، ومن ثم؛ فإنها ليست المعرفة اليقينية، وبالتالي فإن ذات الإنسان تؤثر وتتأثر في إنتاج المعرفة، ومنه صعوبة وصول الإنسان إلى مستوى اليقين. وعلى العكس من ذلك؛ فإن المعرفة تتكون من شقين، شق مصدره الوحي، وعالم الغيب والشهود، ويتمثل في الحقائق والمعايير والقيم، وهو أعلى درجات اليقين، وشق مصدره الفكر البشري -المضبوط بالتصور الإسلامي-، ويتمثل في المعارف والخبرات والمهارات الإنسانية المتغيرة تغير الزمان والمكان، وهذا الشق تغلب عليه الطبيعة البشرية من الخطأ والصواب، ولعل هذا الشق فيه تشابه إلا حد كبير مع ما ذهب إليه إدغار موران، غير أن مفهوم إدغار موران لمصدر المعرفة يتوقف عند الإنسان، ومن ثم فتعريفه، لا يعتبر الوحي مصدراً للمعرفة.
وبإسقاط كلا المفهومين على منهج التربية، يتبين أن مفهوم موران قد خَرَّج إنسانا ماهرا يمتلك ناصية العلوم التقنية، والخبرات والمهارات الإنسانية المتطورة؛ غير أن قيمه لم تزل نسبية، فنراه يستعمل المعرفة في الخير والشر طالما عادت عليه بالنفع المادي، وذلك الفصام يرجع لانفصال القيم عن المعرفة، فمعرفته جامدة ليس للوحي فيها نصيب. وفي المقابل نرى خريج منهج التربية الإسلامية فاقدا للخبرات التقنية والمهارات المتطورة، ولكنه قد امتلك قيما أخلاقية؛ لأن منهج التربية الإسلامية قد قام على الوحي، غير أن منهج التربية الإسلامية لم يقم بإسالة هذه المعرفة في المجتمع المسلم سواء في ميادين الإنتاج، أو في ميدان الاجتماع، فأصبح هذا المنهج مصاباً بالازدواجية، وأمسى خريجه غير قادر على القيام بدوره الاستخلافي في عمارة الأرض، وبشهوده الحضاري على الناس.
2- إصلاح التفكير
إن المعرفة الملائمة -إصلاح التفكير- لتتسارع لتكون السمة الثانية لتربية المستقبل، فإذا كانت السمة الأولى قد اهتمت بالخطأ المعرفي، وتأليه العقل، فإن السمة الثانية قد صبت جُل اهتمامها على تنظيم المعرفة بطريقة ملائمة للعصر، وأصبحت قضية التربية هي: “كيف يمكن معرفة العالم، وكيف يمكن توظيف هذه المعرفة؟ كيف يمكن أن ندرك وأن نحافظ على السياق والشمولي، والعلاقة بين الكل/الأجزاء، والمتعدد والمركب الأبعاد؟ فلكي تكون المعرفة ملائمة للعصر، يجب أن تعمل التربية على توضيح مبادئ أربعة لتحقيق المعرفة وملاءمتها للعصر: السياق، والشمول (علاقة الكل بالأجزاء)، والمتعدد الأبعاد، والمركب.
فبالنسبة للسياق، يوضح موران أهمية وضع المُعطى المعرفي في سياقه حتى يتم الحصول على صحيح المعنى، بقوله: “كل معرفة تعتمد على معطيات أو معلومات معزولة تظل ناقصة. يجب موضعة المعارف والمعطيات داخل سياقها لكي يكون لها معنى، فكل كلمة لكي يكون لها معنى لابد من رجوعها إلى النص الذي هو سياقها الخاص، ويحتاج النص إلى سياق حتى يكون بالإمكان إنتاجه.” ومن هذا يتضح أن وضع المعلومة في سياقها هو شرط لتحقيق المعرفة. وبالنسبة للمبدأ الشمولي، الذي ينصرف معناه لما هو أكثر من السياق، فالشمولي هو: “المجموع الذي يضم أجزاء مختلفة ترتبط به إما بعلاقة ارتدادية أو تنظيمية. مثلاً، إن مجتمعا معينا هو دائماً أكثر من السياق، إنه كلٌ منظم الأجزاء، ولا نشكل نحن سوى جزء منه، والكوكب الأرضي هو أكثر من مجرد سياق، فيشتمل الكل على خصائص لا نجدها في الأجزاء المعزولة.” وبناء على ذلك، فإن معرفة الكل يمكن من معرفة الأجزاء، ومعرفة الأجزاء يمكن من معرفة الكل.
أما بالنسبة للمبدأ الثالث، مبدأ المتعدد الأبعاد، فإن الأشياء مكونة من أبعاد عدة، وعلى تربية المستقبل أن تعترف بهذا التعدد، وأن تدمج معطياته حتى تكون المعرفة الحقيقية، فتعتبر الوحدات المركبة مثل الكائن البشري، أو المجتمع وحدات متعددة الأبعاد، فالكائن البشري هو في الوقت ذاته كائن بيولوجي ونفسي واجتماعي ووجداني وعقلاني. ويضم المجتمع أبعاداً تاريخية وسوسيولوجية ودينية. على المعرفة الملائمة أن تعترف بهذا التعدد، وأن تدمج معطياته، وهنا لا يمكننا فقط فصل الجزء عن الكل، ولكن لا يجب علينا فصل الأجزاء عن بعضها. وأما بالنسبة للمبدأ الرابع، وهو مبدأ المركب، وهو مبدأ ينظر في علاقة الترابط والتفاعل بين الأجزاء، فمثلاً، لا يمكن بناء معرفة ملائمة لأزمة اقتصادية بمعزل عن البحث في باقي العناصر المكونة للكل، فيلزم دراسة الاجتماعي والأخلاقي والسياسي والنفسي. ومن ثم لزم الأخذ بعين الاعتبار علاقة الترابط والتفاعل والارتداد بين موضوع المعرفة وسياقه، وبين الجزء والكل، وبين الكل والأجزاء، والأجزاء فيما بينها، كما يتعين على تربية المستقبل أن تضع جيداً في الحسبان أن مستجدات وتطورات عصرنا الكوكبي تضعنا أكثر فأكثر وبشكل لا رجعة فيه أمام تحديات ما هو مركب.
ونخلص مما سبق، إلى أن على تربية المستقبل أن تطور فكر الإنسان لبناء المعرفة الملائمة للمستقبل، وذلك من خلال تحفيزه على بناء الرؤية الشاملة لتنظيم المعارف وتوظيفها، وأن تتجاوز عقبة تبعثر المعرفة، وأن تُظهر عوار العقلانية التي تُجزئ المعرفة. كما أن عدم بناء معرفة ملائمة يُحدث نوعا من التناقض في بناء المعرفة. فهذا التقدم -الحادث في القرن العشرين- أسفر عن تراجع خطير في المعرفة، بسبب أن التخصص يلغي السياق، ولا يولي أدنى اهتمام للشموليات والمركبات، وبذلك يتم حجب الوقائع الشمولية والمركبة وتقطيع الإنسان، وتجزيء أبعاده بين مختلف القطاعات المعرفية حيث تختص شعبة البيولوجيا بدراسة البعد البيولوجي، وشعبة العلوم الإنسانية بالأبعاد النفسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية المعزولة عن بعضها البعض. نتيجة لذلك يفقد الفكر قدرته الطبيعية على موضعة المعارف داخل سياقها ودمجها داخل إطاراتها الطبيعية، ويُفضي هذا الضعف في إدراك الشمولي إلى إضعاف الإحساس بالمسؤولية، فيتقوقع كل واحد داخل تخصصه، كما يُفضي إلى إضعاف مبدأ التضامن، فكل واحد لا يستشعر أبداً علاقته مع مواطنيه. فمصادر المعرفة الإنسانية في الإسلام هي الوحي السماوي المُنـزَّل، والمعارف والتقنيات المكتسبة، والتراث البشري الموروث في هذين المجالين، وعليه فإن التربية الإسلامية لا بد أن تستمد منهجها ومحتواها من كلٍّ من وحي السماء وميراث المعارف والتقنيات المكتسبة، فإهمال أيٍّ منهما لا يمكن أن يؤدي إلى معرفة متكاملة نافعة أو إلى تربية سليمة.
3- تعليم الشرط الإنساني
على تربية المستقبل أن تنمي وعي الإنسان بوحدته، وبطبيعته المركبة، وكذلك طبيعة الآخرين، وأن تجعل من الشرط الإنساني موضعها الجوهري، ومن شأن هذه التربية أن تنفي الازدواجية عن الإنسان، فيكون هناك “القوي/المؤمن”، فلا احتراف منـزوع الأخلاق، ولا ذو خلق دون احتراف. فعلى التربية أن تعمق مفهومي الوحدة والتنوع البشريين لدى الإنسان، على التربية أن ترسخ فكرة وحدة التنوع البشري، كما ينبغي لها أن تعلم فكرة التنوع دون المساس بفكرة الوحدة، فتهتم بالوحدة الإنسانية بقدر ما تهتم بالتنوع الإنساني، فالوحدة الإنسانية تحمل داخلها مبادئ اختلافاتها المتعددة. أن نفهم الكائن البشري هو أن نتمثل وحدته في قلب تنوعه، وتنوعه داخل وحدته، وباختصار يجب إدراك وحدة المتعدد وتعدد الواحد، وعلى التربية أن تبرز مبدأ الوحدة/التنوع هذا في جميع المجالات.
فالإنسان يحمل في داخله كلاً من خصائص الوحدة، وكذلك خصائص التنوع، “كل كائن بشري يحمل داخله خصائص دماغية وذهنية ونفسية ووجدانية وعقلية وذاتية، إنها في نفس الوقت عبارة عن خصائص مشتركة بين جميع البشر، وعبارة عن خصائص تعكس تفرده.” ومع أهمية انسحاب مبدأ تعلم الشرط الإنساني على تربية المستقبل، لأن غير هذا سوف يعمق الجهل بالإنسان (الكل)، بقدر ما يتحقق من تقدم في مجال المعرفة بالأجزاء (العلوم الإنسانية)، وقد تطرف فريقان في قسمة مبدأ “الوحدة/التنوع”، فمنهم من غالى في الوحدة، ومنهم من تطرف في التنوع، وكلاهما بَعُدَ عن المفهوم الصحيح لمبدأ الشرط الإنساني. إن من يؤمنون بتنوع الثقافات يميلون إلى التقليل من قيمة الوحدة البشرية، وينزع أولئك الذين يقفون عند الوحدة البشرية إلى غض الطرف على تنوع الثقافات، لكن من المهم تدارك الأمر وإدراك وحدة تضمن وتدعم التنوع، بقدر ما يجب طرح التنوع داخل أفق الوحدة. فينبغي على تربية المستقبل أن تتخلص من الأحادية في النظرة إلى الإنسان، فلا يدعي أحد أن له الحق في تنميط الآخر وفق مناهجه هو، وأن وجهة نظره هي التي يجب أن تسود، وأن مبادئه لابد أن تعمم على سائر الخلق، ومن ثم، فإن واجب منهج التربية الإسلامية أن يجعل من هذا الشرط الإنساني ثقافة للمجتمع من خلال دمج المفاهيم في المقررات الدراسية، وكذلك إدماجها في الخبرات التعليمية.
إن الإنسان الفرد هو عضو في جماعة تظل تتسع حتى تشمل الإنسانية كلها بما فيها أسرته وأهله، ومجتمعه وبلده وأمته والعالم بأسره. فهو مرتبط بهذه الجماعات كلها بارتباطات شتى، و له عندها حقوق، كما أن عليه تجاهها واجبات، ولا تستقيم الحياة في هذه الدنيا إلا بقيام اتزان دقيق بين حقوق الفرد وواجباته تجاه الجماعة، وهو أمر من صميم العملية التربوية، ومن صميم الإسلام. وهو من الأمور التي لا يُكتَفى فيها بالتلقين، وإنما لا بد لها من أن تُغرس في النفوس بالممارسة الفعلية وباتباع القدوة الحسنة، والتزام أوامر الله واجتناب نواهيه، والوقوف عند حدوده التي وضعها لعلاقات الأفراد بعضهم ببعض، وعلاقات كل منهم بالمجتمع الإنساني كله على اختلاف أبعاده. والتربية الإسلامية في ذلك لا يمكن أن تكون عملية إقليمية ضيقة، تحدها حدود الأرض، أو فواصل اللغة، أو اختلاف اللون وتنوع الجنس؛ فهي تسعى إلى بناء الإنسان الصالح لتبني به المجتمع الإنساني الصالح، وهو مجتمع لا بد أن يكون مجتمعًا متعلما متبصرًا، يستشعر الفرد فيه معنى الأخوة الإنسانية، ويعتزّ به، ويصونه ويحافظ عليه. وعلى ذلك فالمساواة في التعليم الإسلامي بين عناصر الجنس البشري كلها أمر واجب لا فرق في ذلك بين أبيض وأسود، ولا بين ذكر وأنثى، فكلهم مطالبون بعبادة الله وتقواه، ولا عبادة بغير علم وهدى والتزام.
إن التربية في الإسلام ضرورة إنسانية تُقصَد لذاتها، لا للمردود المادي أو الاجتماعي الذي يمكن أن يعود على الإنسان من وراء تحصيلها، وإن كان ذلك في حد ذاته ليس مستنكَرًا؛ لأن الأصل في التربية الإسلامية أن تكون تأهيلاً للفرد لكي يكون قادرا على تنمية نفسه وأسرته ومجتمعه، لا لمجرد الترف الفكري المنفصل عن التطبيق في الحياة، بل من أجل تحقيق الاستخلاف في الأرض القائم على العمل الدؤوب من أجل التنمية الشاملة للفرد وللمجتمع وللحياة. فالإنسان الفرد عمره محدود، وهو محاسَب على كل مال وصل إلى يديه، وسوف يُسأل من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ ثم إن له بعد هذه الحياة الموت، ومن بعد الموت البعث والحساب، ثم حياة أخرى خالدة يلقى فيها جزاء ما قدمت يداه في هذه الدنيا. هذه الصورة الإسلامية الصادقة للوجود الإنساني بصفة عامة ولحامل القرآن الكريم بصفة خاصة تجعل له معنى لا يمكن أن يتحقق إذا كانت حياته مقصورة على هذه الدنيا فقط، ولذلك فإن التربية الإسلامية تبعث في الإنسان الضمير الحي الذي يحاسبه دوما قبل أن يحاسَب، ويَزِنُ عليه أعماله قبل أن توزَن عليه في عملية من المراجعة الذاتية الآنية المستمرة التي تعمل على تطهير قلبه وتزكية نفسه، وتدفعه إلى المسارعة في عمل الخيرات باستمرار، في شمولٍ وكمال تعجز كلُّ النُّظُم التربوية الأخرى عن تحقيق شيء منه.

4- تعليم الهوية الأرضية
العالمية هي المصير المشترك للإنسان، وعلى التربية أن تبين “أن البشر يشتركون منذ الآن في نفس مشاكل الحياة والموت، ويعيشون مصيراً مشتركاً.” ففي هذا الزمن -التي تتلاشى فيه الحدود تدريجياً، ويتسارع زمن الاتصال عن بعد، وتضاعف التفجر المعرفي عبر شبكة المعلومات، وإدماج العالم رغم أنفه في سوق عالمية- تبدو الكرة الأرضية أنها تنزع لأن تكون كُلاً، ويعبر موران عن ذلك “الكُل” بقوله: “أصبح العالم أكثر فأكثر عبارة عن كل، فكل جزء في العالم أصبح أكثر فأكثر عبارة عن جزء لا يتجزأ من هذا العالم. كما أن العالم بما هو كل أصبح حاضراً أكثر فأكثر داخل أجزاء كل جزء من أجزائه.”
فالنظرة الأحادية للكائن البشري أورثته القلق، والاكتئاب، والخوف، واليأس، والشعور بالضياع. لقد أورثت هذه النظرة التربية بمادية حطمت الإنسان، وسلبت روحه، فلذا على تربية المستقبل أن تُبرز وتشخص المصير المتعدد للإنسان، أي مصيره كنوع بشري، ومصيره كفرد، ومصيره الاجتماعي والتاريخي، وكلها مصائر متكاملة ومتعلقة فيما بينها بشكل قوي. وعلى تربية المستقبل أن تدفع نحو المعرفة والوعي بالشرط الإنساني المشترك لكل البشر، وكذا الوعي بغنى وضرورة تنوع الأفراد والثقافات والشعوب، وأخيراً على التربية أن تدفع نحو تجذر بني البشر كمواطني هذه الأرض. ففي ظل الأزمة التي اجتاحت وعصفت بسوق المال في العالم عام 2009م، والتي نشأت في المجتمع الغربي، نرى أن الإنسان في بقية العالم تحمل تبعات هذه المشكلة دونما أن يكون له فيها نصيب، “فبينما يستمتع الأوروبي داخل هذا المدار الكوكبي الرغد، ثمة عدد كبير من الأفارقة والآسيويين و الجنوب-أمريكيين يعيشون داخل مدار كوكبي بئيس، إنهم يتحملون في حياتهم اليومية عواقب السوق العالمية.”
من الواضح الجلي أن القرن الواحد والعشرين قَدُمَ مزداناً بتقدم مادي كليل، ولكنه في نفس الوقت ورث من سالفه توحشاً ضارياً، إلا أن القرن العشرين تميز كذلك بنوعين من التوحش: النوع الأول مصدره عمق الزمن الذي نعيش فيه والحابل بالحرب، والمذبحة، والمنفى، والتعصب. والنوع الثاني يحيل على شكل من التوحش بارد مجهول، مصدره البنية الداخلية للتبرير العقلاني، والذي لا يعترف إلا بما هو قابل للحساب ويتجاهل الأفراد، يتجاهل شهواتهم، وأحاسيسهم، وأرواحهم، الشيء الذي يضاعف قوى الموت والاستعباد التقنو-صناعي.
ولقد وصل هذا الأمر من السوء بعد الانقطاع عن الدين -الذي يوصم بأنه من موروثات الماضي- وتبني فلسفة مادية بحتة أَلّهت العقل، وعبدت وحدانية السوق، فكان الشقاء الذي يوزع إرثه بالقوة الجبرية على فقراء العالم، فلقد ولدت الحضارة في الغرب عبر القطع مع الماضي، معتقدة أنها تتوجه نحو مستقبل حافل بالتقدم اللانهائي، وذلك بفضل التقدم الموازي في مجالات العلم والعقل والتاريخ والاقتصاد والديمقراطية. إلا أننا تعلمنا من دروس هيروشيما، أن العلم سلاح ذو حدين: إذ شاهدنا كيف تراجع العقل، وكيف أن الهذيان الستاليني اتخذ قناع العقل التاريخي، لقد تبين لنا أنه لا وجود لقانون تاريخي سيقود حتماً نحو مستقبل مشرق، لقد رأينا كذلك كيف أن انتصار الديمقراطية لم يتحقق بشكل نهائي في أي مكان، كما رأينا أن التنمية الصناعية يمكن أن تنتج عنها أضرار ثقافية، وأنواع من التلوث القاتل. لقد رأينا أن حضارة الرفاهية يمكن أن تكون في نفس الوقت سبباً في الشقاء. إذا كانت الحداثة تتحدد بما هو إيمان غير مشروط بالتقدم في مجال التقنية والعلم، وفي التنمية الاقتصادية، فبإمكاننا القول إن هذه الحداثة قد ماتت.
ولذا، فإن على تربية المستقبل أن تربي الإنسان كيف يعيش فوق كوكب الأرض -وطن الإنسان- وكيف يتواصل مع أخيه الإنسان، وكيف يتقاسم بني البشر الأشياء دون استحواذ من فئة معينة ودون سيطرة أمة محددة، وأن ما تعلمته البشرية كلاً وفق خصوصيته، عليها أن تتعلمه وفق الهوية المشتركة لكوكب الأرض. لذلك علينا أن نتعلم كيف “نكون هنا” فوق الكوكب. ونعني بقولنا أن نكون هنا، أن نتعلم كيف نعيش، كيف نتقاسم الأشياء بيننا، وكيف نتواصل، وكيف نتوحد فيما بيننا، فهذا شيء نتعلمه فقط في ومن خلال ثقافتنا الخصوصية. بينما يتعين علينا من الآن فصاعدا أن نتعلم كيف نعيش، كيف نتقاسم الأشياء بيننا، وكيف نتواصل، وكيف نتوحد فيما بيننا باعتبارنا أناساً ينتمون لكوكب الأرض، وبالتالي علينا أن نرسخ بداخلنا ما يلي:
-الوعي الأنثروبولوجي، والذي يعترف بوحدتنا في إطار تعدديتنا.
-الوعي الإيكولوجي أي الوعي بأننا نعيش مع الكائنات الفانية داخل نفس المحيط الحيوي.
-الوعي المدني الأرضي، ونقصد بذلك الوعي بالمسؤولية والتضامن مع أطفال الأرض.
-الوعي الحواري، والذي يُكتسب من خلال ممارسة مُرَكّبة للتفكير.
5- تعليم الفهم
إن أحد الأسباب الرئيسة لتمزق العالم يرجع إلى غياب الفهم، وذلك بغيابه عن المؤسسات التربوية، ومن ثم ينتج هذا الغياب غياباً للسلام بين بني البشر، فالفهم وسيلة لتنمية الوعي الحواري، وسياج حام من الوقوع في مزالق الخطأ والوهم المعرفي، والطريق للبعد عن هيمنة المعرفة المجزأة، وهو الرابط بين الأجزاء والكليات، وهو السبيل للاعتراف بالآخر و التواصل بين بني البشر. ويشكل الفهم في الوقت ذاته وسيلة التواصل الإنساني وغايته، والحال أن التربية على الفهم غائبة كلياً عن مختلف أنواع تعليمنا. إن كوكبنا يتطلب أنواعاً من الفهم المتبادل في جميع المستويات وعلى جميع الأصعدة. وبالنظر إلى أهمية التربية على الفهم على جميع المستويات التربوية وكل المراحل العمرية، يقتضي الفهم إصلاحاً للعقليات، وهذا أحد الرهانات الكبرى للتربية في المستقبل.
فإذا كانت الفائدة من الفهم بهذا القدر، فلابد من أن استحواذه على النصيب الأكبر في المنظومة التعليمية، بل لابد أن يكون غاية من غايات التربية في المستقبل، والفهم ليس مرادفاً للعلم، بل هو ربيب الفقه، فلا تقنية من تقنيات التواصل، من هاتف، ومن انترنيت تحمل في ذاتها خاصية الفهم، لا يمكن إضفاء الطابع الرقمي على الفهم. ثمة فرق بين أن نربي من أجل تحصيل الفهم في الرياضيات أو في مادة تعليمية أخرى، وبين أن نربي من أجل اكتساب الفهم الإنساني، وهنا تتجلى الرسالة الروحية المحضة للتربية في تعليم الناس الفهم، والذي هو الشرط والضامن لتحقق التضامن العقلي والأخلاقي للإنسانية.
وإضافة لما سبق، يتضح أن هناك مستويان من الفهم هما: الفهم العقلي أو الموضوعي، والفهم الإنساني. فالفهم عقلياً أو موضوعياً يعني أن نصل سوياً إلى ضبط واستيعاب شيء ما، ويشترط الفهم العقلي الوضوح والتفسير، فالتفسير يعني أن موضوع المعرفة بمثابة شيء يُطبق عليه كل الوسائل الموضوعية في المعرفة، وهو ضروري بالنسبة للفهم العقلي والموضوعي. إلا أن الفهم الإنساني يتجاوز حدود التفسير، فالتفسير يكون كافياً من أجل الفهم العقلي أو الموضوعي المتعلق بأشياء مجردة أو مادية، لكنه غير كاف عندما يتعلق الأمر بالفهم الإنساني، فلابد للفهم الموضوعي أن يُحيل الفهم الإنساني على معرفة الذات للذات. هكذا، فإذا رأيت طفلاً يبكي سأفهمه، ليس اعتماداً على قياس درجة ملوحة دموعه، ولكن اعتمادا على الغوص في أعماقي واستخراج كل الشدائد التي عشتها في طفولتي، وبما أن الفهم مسألة بين ذاتية، فإنه يقتضي بالضرورة الانفتاح، والتعاطف، والأريحية.
أما عوائق الفهم فتنقسم إلى عوائق خارجية وأخرى داخلية، فأما الخارجية فهي: الضجيج الذي يشوش على نقل الخبر، و تعدد معاني مفهوم ما، والذي نقصد به معنى ما وقد يعطيه الآخر معنى مغايراً، وهناك الجهل بطقوس وعادات الغير، و عدم الفهم اتجاه القيم الإلزامية المتعلقة بثقافة مغايرة، و عدم فهم اتجاه الالتزامات الأخلاقية الخاصة بثقافة ما، وهناك في الغالب عدم تملك رؤية معينة للعالم، و في الأخير، استحالة فهم بنية عقلية لبنية عقلية مغايرة. أما العوائق الداخلية الخاصة بكلا نوعي الفهم، فهي عوائق متعددة، إنها لا تختزل فقط في اللامبالاة، ولكن أيضاً في نزعة التمركز حول الذات، ونزعة التمركز حول العرق، ونزعة التمركز حول المجتمع. إن القاسم المشترك بين هذه النزعات الثلاث، يكمن في كونها تموقع ذاتها في مركز العالم، وتعتبر كل ما هو غريب أو بعيد شيئا ثانويا، لا معنى له، أو شيئا معاد لها.
تؤدي نزعة التمركز حول الذات إلى عدم فهم الذات، ومن ثم عدم فهم الآخر، فهي تدعو “إلى اللجوء إلى التبرير الذاتي، وإلى تزكية الذات، والميل نحو جعل الغير مصدر كل الشرور، كما نعمل على انتقاء ما هو جليل في ذكرياتنا، وإقصاء أو تحويل ما هو غير مشرف فيها.” ويلي ذلك تمركز الذات حول العرق، وحول المجتمع، وهاتان النزعتان تؤديان إلى كراهية الأجانب والنزعات العنصرية، “ومن النزعات العنصرية، والتي يمكن أن تصل إلى حدود نزع صفة الإنسان عن الأجنبي.” وتعدد مسببات عدم الفهم مثل: “الأفكار المسبقة، وأنواع التبرير العقلاني المعتمدة على أوليات اعتباطية، وتبرير الذات بشكل جنوني، والعجز عن النقد الذاتي، واعتماد طريقة ذهنية في البرهنة، والكبرياء، والجحود، والاحتقار، وخلق متهمين وهميين والعمل على محاكمتهم.” والاختزال من الأسباب الرئيسة في عدم الفهم للآخر، بمعنى أن يُختزل المركب في جزء من أجزاءه، ومثال على ذلك، اختزال شخصية متعددة بطبيعتها في إحدى خصاصها، فإذا كانت هذه الخاصية إيجابية، فمعنى ذلك أنه سيتم تجاهل الخواص السلبية لهذه الشخصية. وإن كانت سلبية، فمعنى هذا أنه سيتم تجاهل خصائصها الإيجابية. وفي كلتا الحالتين نحن أمام عدم الفهم.”
فأخلاق الفهم تعني فن العيش مع الآخر، وهذا يتطلب أن تتم التربية على معان، كالتخلي عن التمركز حول الذات والعرق والمجتمع، فلا نستبق الأحكام على الآخر، ولا نمنع أنفسنا من الاعتراف بالخطأ، وأن نتجنب الإدانة القطعية، غير القابلة لإعادة النظر. ومن الأشياء التي تعزز النظر، التفكير الجيد، فنمط التفكير هو الذي يسمح لنا بفهم الشروط الموضوعية والذاتية للسلوك الإنساني. وكذلك الاستبطان، وهي الممارسة الذهنية المتجلية في الفحص الذاتي، لأن فهم نقاط ضعفنا الخاصة أو نواقصنا، هو السبيل نحو فهم نقاط ضعف ونواقص الغير. وكذلك، الوعي بالطابع المركب للإنسان، وهو الوعي بضرورة عدم اختزال كائن ما في الجزء الأصغر من ذاته، ولا في أسوأ لحظة من ماضيه. وكذلك استدخال التسامح، والذي يعني افتراض وجود قناعة، أو إيمان، أو اختيار أخلاقي لدينا، بل نقبل في نفس الوقت بالتعبير عن أفكار، وقناعات، واختيارات مناقضة لتلك التي لدينا نحن.
فعلى تربية المستقبل يقع تعميق الفهم الإنساني بين البشر، وعلى الثقافات أن تتعلم من بعضها البعض، وعلى الثقافات الغربية المتكبرة، التي فرضت نفسها كثقافة معلمة، أن تصبح ثقافة متعلمة أيضاً، أن يُسمح لكل ثقافة أن تتغذى من ثقافات العالم ككل، ومن خلال أعمالها الخاصة تعمل كذلك على إغناء ما يمكن تسميته بخليط ثقافي كوكبي، إن تطور الخليط الثقافي، والذي ما زال محدوداً، هو خاصية مميزة للجزء الثاني من القرن العشرين، ويجب أن يُتمم في القرن الواحد والعشرين.
ويؤكد الهيتي على أن الفهم في الواقع العربي فهم منقوص، فهناك عدة أطراف قد توفرت على تجذير الفهم المنقوص، فمنهم من يعمل على تأجيج العواطف واستخدام الاستمالة العاطفية، ومنهم من يفكر بعقل مستعار، وبمنهجية مستوردة، وكلا الطرفان يشترك في إعطاء أجوبة معّلبة عن الأسئلة التي يفرزها الواقع. وبالمقابل؛ فإن عصور النهضات في أي مجتمع هي التي ظهر فيها فهم جديد للطبيعة والحياة؛ إذ ساعد ذلك الفهم على التطور والنهوض، ولما كان تحقيق “الفهم” هو وليد التفكير العلمي؛ فإن التربية هي الطريق لإدخال الروح العلمية في الوعي بالمستقبل.
المصادر والمراجع:
1) الآدمي، عمران سميح. المقدمة في دستور المعرفة والعلوم. عمان: دار القُرّاء للنشر. د. ط، 1419هـ.
2) النجار، زغلول. البناء التربوي لتلميذ القرآن. http://www.hiramagazine.com/archives_show.php?ID=158&ISSUE=8
3) الهيتي، هادي نعمان. (2003م). إشكالية المستقبل في الوعي العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. ط1.
4) موران، إدجار. تربية المستقبل. دار توبقال. الرباط.
 تعليم جديد أخبار و أفكار تقنيات التعليم
تعليم جديد أخبار و أفكار تقنيات التعليم








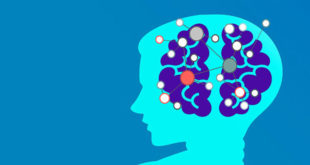
شكرا د. عبد المقصود سالم جعفر
لكني دوما ارى الكلام النظري المطول العاري عن التطبيق العملي مناسب للاكاديميبن و ايس التطبيقيين ..و مع حرصي على معرفة اليات التقدم في الجانب التربوي لكني كسلت عن قراءة هذا الكلام المطول اريد تطبيقا عمليا ..
موقع مهم و مفيد